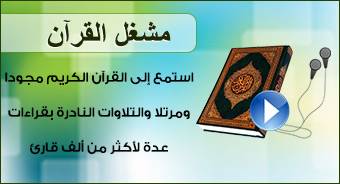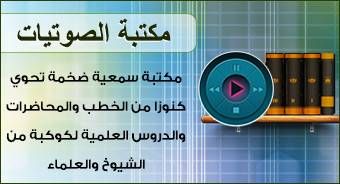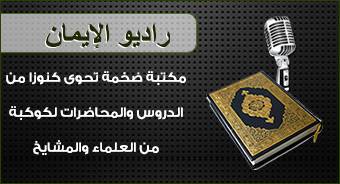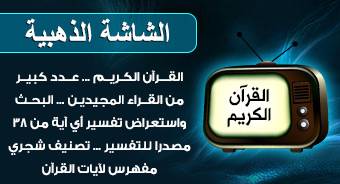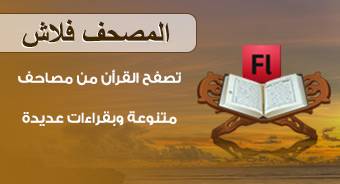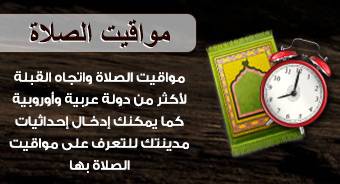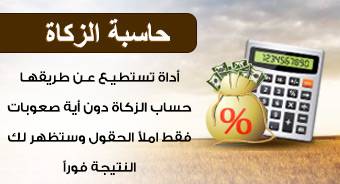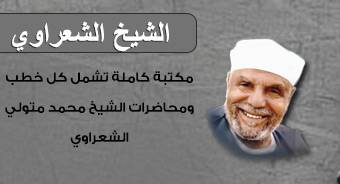|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
اصطلاحا: هو إزالة الملك أو الحق لا إلى مالك ولا إلى مستحق تسقط بذلك المطالبة به لأن الساقط ينتهى ويتلاشى ولا ينتقل وذلك كالطلاق، والعتق، والعفو عن القصاص، والإبراء من الدين. فوائد: - الحط: يستعمل بمعنى الإسقاط، ويفرق بينهما: أن الإسقاط يستعمل في إسقاط الحامل الجنين، وكذا يستعمل الحط في إسقاط حق في ذمة آخر على سبيل المديونية.- الإبراء: يقع على حق ثابت بالشرع لم تشغل به الذمة كحق الشفعة، ويكون بعوض وبغير عوض، فالإبراء أخص من الإسقاط، فكل إبراء إسقاط ولا عكس. - الإبطال: الفرق بين الإسقاط والإبطال: أن الإسقاط فيه رفع لحق ثابت، وفي الإبطال منع لقيام الحق والالتزام. - العفو: أعم من الإسقاط لتعدد استعمالاته. - التمليك: إزالة ونقل إلى مالك، والإسقاط إزالة وليس نقلا، كما أنه ليس إلى مالك، فالإسقاط أعم من التمليك. انظر: [المفردات ص 235، والتوقيف ص 408، والكليات ص 515، والاختيار 3/ 121، والذخيرة 1/ 102، وشرح منتهى الإرادات 3/ 122، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 57، والموسوعة الفقهية 1/ 143، 180، 4/ 126، 226، 227، 6/ 185، 30/ 168].
من النصارى: العالم الرئيس، والجمع: أساقفة. وفي حديث البخاري في الوحي: «وكان ابن الناطور أسقف على نصارى الشام». [البخاري (بدء الوحي/ 6)] انظر: [المصباح المنير (سقف) ص 107، ونيل الأوطار 6/ 210].
اصطلاحا: تغطية العقل بما فيه شدة مطربه كالخمر، ويرى جمهور الفقهاء أن ضابط الإسكار هو أن يختلط كلامه فيصير غالب كلامه الهذيان حتى لا يميز بين ثوبه وثوب غيره عند اختلاطهما، ولا بين فعله وفعل غيره، وذلك بالنظر لغالب الناس، وقال أبو حنيفة: السكران الذي لا يعرف السماء من الأرض، ولا الرجل من المرأة. انظر: [الموسوعة الفقهية 4/ 258].
انظر: [التوقيف ص 62].
انظر: [المطلع ص 365].
وأسل: أي صار ذا سلّة، وإذا أعان غيره عليه، ويقال: الإسلال: الغارة الظاهرة. [المصباح المنير (سلّ) ص 109، والنهاية 2/ 392، وطلبة الطلبة ص 217].
أما في الشرع، فيختلف معناه تبعا لوروده منفردا أو مقترنا بالإيمان. فمعناه منفردا: الدخول في دين الإسلام أو دين الإسلام نفسه. والدخول في الدين: استسلام العبد لله باتباع ما جاء به الرسول صلّى الله عليه وسلّم من الشهادة باللسان والتصديق بالقلب أو العمل بالجوارح. قال الجرجاني: الإسلام: هو الخضوع والانقياد لما أخبر به الرسول صلّى الله عليه وسلّم. وفي (الكشاف): أن كل ما يكون الإقرار باللسان من غير مواطأة القلب فهو إسلام، وما واطأ فيه القلب اللسان، فهو إيمان. أقول: هذا مذهب الشافعي. وأما مذهب أبي حنيفة: فلا فرق بينهما- ومعناه إذا ورد مقترنا بالإيمان: هو أعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل كالشهادتين والصلاة وسائر أركان الإسلام، وإذا انفرد الإيمان يكون حينئذ بمعنى الاعتقاد بالقلب والتصديق بالله تعالى، وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره مع الانقياد- فهما من الألفاظ التي إذا اجتمعت انفردت، وإذا انفردت اجتمعت، فإذا انفرد كل منهما كان بمعنى الآخر، وإذا اجتمعا كان الإيمان بمعنى التصديق، والإسلام بمعنى الانقياد الظاهري لأوامر الشرع ونواهيه. [المفردات للراغب ص 240، والكليات ص 112، وجامع العلوم والحكم لابن رجب ص 102- 111، والتعريفات ص 18، والموسوعة الفقهية 2/ 259].
انظر: [طلبة الطلبة ص 240].
انظر: [المطلع ص 334].
(أ) بمعنى: إمالة الشيء إلى الشيء حتى يعتمد عليه. (ب) ويأتي أيضا بمعنى: رفع القول إلى قائله ونسبته إليه. اصطلاحا: يأتي لمعان: (أ) إعانة الغير كالمريض مثلا بتمكينه من التوكي على المسند ونحوه إسناد الظهر إلى الشيء. (ب) ما يذكر لتقوية القضية المدعاة. والكلام فيه تحت عنواني الإضافة، ومنه قولهم: إسناد الطلاق إلى وقت سابق. (ج) وعند علماء الحديث: الطريق الموصل إلى متن الحديث. (د) وعرفه الجرجاني: بأنه ما يكون المنع مبنيّا عليه، أي: ما يكون مصححا لورود المنع إما في نفس الأمر أو في زعم السائل. وللسند صيغ ثلاث انظرها في (التعريفات). [المصباح 291 (علمية)، والكليات ص 100، والتعريفات ص 121 (علمية)، والموسوعة الفقهية 4/ 284].
انظر: [طلبة الطلبة ص 330].
الأول: جعل الشخص صاحب حصة أو نصيب. يقال: أسهمت له بألف، يعنى أعطيته ألفا، ويصبح الشخص ذا سهم في أمور منها: الميراث، والقسمة، والغنيمة، والفيء، والنفقة، والشرب إن كان له استحقاق في ذلك. الثاني: الإقراع. يقال: أسهم بينهم: أي أقرع بينهم. ولا يخرج استعمال الفقهاء عند هذين المعنيين. انظر: [الموسوعة الفقهية 4/ 276].
انظر: [نيل الأوطار 2/ 336].
قال ابن سيده: وأرى الأخيرة على تقدير الهاء. وقال كثير عزة: وتوشح الرجل بثوبه وبسيفه، وقد توشحت المرأة واتشحت الجوهر، وشاح ينسج من أديم عريض ويرصع بالجوهر وتشده المرأة بين عاتقيها. وقول دهلبا ابن قريع يخاطب ابنا له: يعنى: الوشاح (وشح). [معجم الملابس في لسان العرب ص 32].
والإشارة في الاصطلاح: عند الأصوليين: هي دلالة اللفظ على ما لم يقصد به، ولكنها لازمة له. كدلالة قوله تعالى: {لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [سورة البقرة: الآية 236] على صحة النكاح. أما عبارة النص، فهي المعنى الذي يتبادر فهمه من صيغته، ويكون هو المقصود من سياقه: هو الثابت بنفس الصيغة من غير أن يسق له الكلام. التلويح بشيء يفهم منه النطق، فهي مرادف النطق في فهم المعنى. إشارة النص: ما عرف بنفس الكلام بنوع تأمل من غير أن يزاد عليه بشيء أو ينقص عنه. هو العمل بما ثبت بنظم الكلام لغة لكنه غير مقصود ولا سيق له النص كقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ} [سورة البقرة: الآية 233]. سيق لإثبات النفقة، وفيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء، وأن الأب لا يشاركه أحد في النفقة على الولد، فالإيماء عندهم أخص من الإيماء عند غيرهم من الفقهاء واللغويين، سواء في مفهوم الإيماء والإشارة مطلقا أو الخفية، وأجاز الغزالي تسمية الإيماء إشارة. انظر: [ميزان الأصول، السمرقندي ص 397، والتعريفات ص 21، وشرح مسلم، البعوث 1/ 407، 413، والمستصفى 2/ 188- 190، والتوقيف ص 65، 66، وغاية الوصول ص 37، والموسوعة الفقهية 4/ 277].
اصطلاحا: نشر الأخبار التي ينبغي سترها لشين الناس، ومنه الحديث: «أيّما رجل أشاع على رجل عورة ليشينه بها». [النهاية (2/ 521)] مصدر أشاع، وأشاع ذكر الشيء: إطارة وأظهره، وشاع الخبر في الناس شيوعا: أي انتشر وذاع وظهر، وقد تطلق الإشاعة على الأخبار التي لا يعلم من أذاعها، وكثيرا ما يعبر الفقهاء عن هذا المعنى بألفاظ أخر غير الإشاعة كالاشتهار، والإفشاء، والاستفاضة. أشاع الخبر بمعنى: أظهره فانتشر. انظر: [المصباح المنير ص 329، (علمية)، والموسوعة الفقهية 3/ 80، 4/ 286، 5/ 297، والقليوبي 4/ 32، ط الحلبي].
الأشافى: جمع الأشفى: وهو المخرز، قال المناوي: آلة الإسكاف وسيأتي في: الاشفى. [طلبة الطلبة ص 148، والتوقيف ص 67]. |